أصبح الرجال المعاصرون أكثر وحدة من أي وقت مضى. فبين الأدوار المتغيرة للجنسين، والإرهاق العاطفي، وثقافة المواعدة التي تترك الكثيرين في حالة من خيبة الأمل، يتصارع جيل كامل مع إحساسه بذاته ويبحث عن معنى.
إنها الثانية صباحًا والضوء الوحيد في شقتي يأتي من مصابيح الشارع التي تتسلل من خلال الستائر. أجلس على حافة سريري، مغمورًا بخطوط من الظل والضوء، وأشعر بالوحدة أكثر من أي وقت مضى. في لحظات مثل هذه اللحظات، يكون الصمت مطبقًا - وهو تذكير ثقيل بأن الوحدة الذكورية الحديثة حقيقية ومنتشرة وغالبًا ما تكون غير مرئية. وأنا أعلم أنني لست الرجل الوحيد الذي يعيش هذا الواقع.
في عصر التواصل الدائم، يشعر الكثير منا بالانفصال بشكل متناقض. على الورق، لدينا جميع الأدوات اللازمة للتواصل - الهواتف الذكية، وشبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المواعدة - ومع ذلك غالبًا ما تنتهي ليلة بعد ليلة بشعور زاحف بالفراغ. نقوم بالتمرير والتمرير بحثًا عن شرارة التواصل، ولكن غالبًا ما ينتهي بنا المطاف حيث بدأنا: وحيدين مع أفكارنا. لسنوات، كان المجتمع يقول للرجال أن الأمر سهل علينا، وأننا يجب أن "نتحلى بالرجولة" وأن نكون أقوياء ونحتفظ بمشاكلنا لأنفسنا. ولكن خلف الأبواب المغلقة، يعاني عدد متزايد من الرجال في صمت من مشاعر العزلة والإرهاق وفقدان الهدف. لا يقتصر الأمر على ما يدور في رؤوسنا فقط - فقد تغير شيء أساسي فيما يعنيه أن تكون رجلًا اليوم، ويحاول الكثير منا فهم مكاننا في عالم يبدو أنه قد مضى قدمًا بدوننا.
الوباء الهادئ للوحدة
بالنسبة للكثير من الرجال، لا تقتصر الوحدة بالنسبة للكثير من الرجال على كونهم غير مرتبطين أو ليس لديهم خطط في ليلة الجمعة، بل هو شعور أعمق من كونهم غير مرئيين. تجول في أي شارع من شوارع المدينة أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تلاحظ ظاهرة مثيرة للاهتمام: عدد لا يحصى من الرجال الذين يندمجون في الخلفية ويحملون أعباءهم بصمت. هناك مقولة يتم تداولها بنبرة خافتة: يصبح الرجال غير مرئيين مع تقدمهم في العمر. في العشرينات من العمر، ربما كنا لا نزال نشعر بأننا ما زلنا نشعر بأننا ملاحظين - من قبل الشركاء المحتملين، من قبل المجتمع الذي يتوقع منا أشياء. ولكن مع مرور السنوات، إذا لم تصل إلى المعالم التي يتوقعها المجتمع (الحياة المهنية المزدهرة، والزواج، والأطفال)، تبدأ بالشعور بأنك شبح في حياتك الخاصة. أنت هناك، ولكن لا أحد يراك حقًا.
يلقي العديد من الرجال بأنفسهم في العمل أو المشاريع الشخصية للتغلب على هذا الفراغ، ليجدوا أنفسهم منهكين في سن الخامسة والثلاثين أو الأربعين، دون أن يظهروا الكثير من الجهد العاطفي. نحن نكد ونكدح في العمل، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن هذا هو المجال الوحيد الذي تعلمنا فيه أن نثبت جدارتنا. ومع ذلك، حتى في العمل، غالبًا ما لا يأتي التقدير في كثير من الأحيان - أو إذا حدث ذلك، فإنه يبدو فارغًا عندما لا يوجد أحد لمشاركة النجاح معه في المنزل. والنتيجة؟ الإرهاق الهادئ والمضني. إنه ليس مجرد إرهاق جسدي؛ إنه الإرهاق العاطفي الناجم عن سنوات من محاولة الارتقاء إلى مستوى التوقعات دون نظام دعم قوي. تعود إلى المنزل لتجد الشقة فارغة، وتغوص في الأريكة، وتتساءل عن سبب كل هذا الجهد المبذول.
يمكن أن تصيبنا الوحدة حتى عندما نكون مع الناس. قد تكون في الخارج مع مجموعة من المعارف في الحانة، تضحك وتقرع الكؤوس، ومع ذلك تشعر بالوحدة التامة وسط الحشد. إنه الإحساس بأن لا أحد يعرفك حقًا أو حتى يهتم بمعرفتك تحت المزاح السطحي. غالبًا ما تتوقع منا الذكورة الحديثة أن نرتدي درعًا من الثقة واللامبالاة الباردة - أن نكون غير مزعجين ومعتمدين على أنفسنا ولا نظهر مدى احتياجنا للآخرين. ولكن داخل هذا الدرع، يتوق الكثير منا إلى التواصل الحقيقي، إلى أن يسألنا شخص ما بصدق عما إذا كنا بخير (وأن نبقى في الجوار للحصول على إجابة صادقة). نحن نتوق إلى أن يرانا الآخرون، بعيوبنا وكل عيوبنا، ولكننا نخشى أن يجعلنا الاعتراف بهذا التوق أقل رجولة. إنها حلقة مفرغة: نحن نشعر بالوحدة لأننا لا نظهر أبدًا ذواتنا الحقيقية، ولا نظهر أبدًا ذواتنا الحقيقية لأنه يُطلب منا ألا نكون وحيدين.
الأدوار المتغيرة واليقين المفقود
لماذا وصل الأمر إلى هذا الحد؟ يكمن جزء من الإجابة في مدى التغير الجذري الذي طرأ على المشهد الاجتماعي في جيل واحد. فكروا في أجدادنا أو حتى آبائنا: بالنسبة لهم، كانت الحياة بالنسبة لهم تتبع نصًا واضحًا ومباشرًا. كن معيلًا وتزوج وكن "رجل البيت". إذا حددوا هذه الخانات، اعتبرهم المجتمع رجالاً ناجحين. كان تعريف الرجولة ضيقًا وتقليديًا - ونعم، غالبًا ما كان قمعيًا بطريقته الخاصة - لكنه كان واضحًا. أما اليوم، فقد تمزق ذلك النص القديم. فمن ناحية، هذا أمر محرر: لم نعد محصورين في أن نكون فقط المعيل الرزين أو الأب البعيد الذي لا يظهر أبدًا أي مشاعر. ولكن من ناحية أخرى، يشعر الكثير منا وكأننا ممثلون أُلقي بنا على خشبة المسرح دون أي سيناريو على الإطلاق. فالأدوار التي كنا مستعدين لها إما اختفت أو تغيرت بشكل جذري، ونحن نرتجل في الوقت الحقيقي، وأحيانًا بشكل أخرق.
في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، طالبت النساء بحق بمساحة أكبر في التعليم والعمل والقيادة. إنهن لا الحاجة الدعم المالي أو الحماية من الرجل بالطريقة التي كانت تتمتع بها في الماضي، وهذه علامة على التقدم نحو المساواة. ولكن مع توسع أدوار المرأة، لم يتوسع الدور التقليدي للرجل استجابةً لذلك بقدر ما تآكلت أدواره. لم تعد التوقعات القديمة - كن قويًا، كن معيلًا جيدًا، كن مسؤولاً - تنطبق تلقائيًا، وأصبحت التوقعات الجديدة تُكتب على عجل. يُطلب منا الآن أن نكون أكثر حساسية ولكن ليس ضعفاء. أن نحترم النساء ونتكيف مع قوتهن، ولكن بطريقة أو بأخرى ألا نفقد قوتنا في هذه العملية. أن نقود عند الضرورة، ولكن أيضًا أن نؤجل ونستمع. إنها تضاريس مربكة. نحن نؤمن بالمساواة، ونريد لشركائنا وزملائنا وأصدقائنا أن يزدهروا. ولكن في اللحظات الخاصة، يتساءل الكثير منا: ما هو دوري الآن؟ أين أنا مطلوب، إن كان هناك حاجة لي؟
لقد تغيرت ديناميكيات السلطة في العلاقات والمجتمع ككل، ومع هذا التحول يأتي فقدان السلطة التلقائية التي كان الرجال في العصور الماضية يعتبرونها من المسلمات. والحق يقال، لا بأس في ذلك - لا ينبغي أن يأتي الاحترام على طبق من فضة فقط بسبب جنسك. لكنه تعديل. لقد نشأ بعضنا بهدوء على افتراض أننا إذا عملنا بجد وقمنا "بكل الأشياء الصحيحة"، فإننا سنكسب احترامًا ومكانة معينة. وبدلاً من ذلك، نجد أن الاحترام يجب أن نكتسبه يوميًا وحتى ذلك الحين يمكن أن يكون بعيد المنال. حتى أننا في بعض الأماكن، نشعر في بعض الأماكن بأننا موضع شك لمجرد كوننا ذكورًا - كما لو أن أي إظهار للحزم قد يُنظر إليه على أنه سام، وأي ضعف على أنه غير رجولي. نحن نخطو بحذر، فنحن لا نريد أن يتم وصفنا بالشخص السيئ، ومع ذلك فإن هذه المراقبة الذاتية المستمرة تجعلنا غير متأكدين من كيفية التصرف على طبيعتنا. نحن لا نريد أن نكون رجالًا متسلطين كما كان أجدادنا من قبل، ولكننا لم يُعرض علينا مخطط بديل واضح للرجولة الصحية. لذا فنحن نحوم في مأزق غريب، غير واثقين من أنفسنا، وهذا الشك يأكل من قيمتنا الذاتية.
الحب والجنس وجحيم المواعدة الجديد
كان من المفترض أن تكون المواعدة أسهل مع وجود تطبيقات وفرص لا حصر لها في مدينة كبيرة. وبدلاً من ذلك، غالباً ما أشعر أنني ذلك الشخص الوحيد تحت ضوء شارع بعيد في الضباب، أتجول في طريق فارغ في جوف الليل. كل ملف تعريف ساطع على هاتفي يشبه وخزة ضوء في الظلام - مغرٍ ومفعم بالأمل، ولكنه غالبًا ما يكون بعيد المنال. لقد فقدت عدد المواعيد الغرامية الأولى التي لم تؤدِ أبدًا إلى موعد ثانٍ، والمقابلات التي تحولت إلى محادثات نصية لمدة أسبوع ثم لا شيء، ومضات قصيرة من الاتصال التي انطفأت بسرعة كما اندلعت شرارتها. إنه أمر مرهق. فبدلاً من الرومانسية، ما يجده الكثير منا هو سلسلة من اللقاءات السطحية والرفض الذي يجعلنا أكثر حذرًا من ذي قبل.
إن ثقافة المواعدة الحديثة لها مزاياها - خيارات أكبر، والقدرة على مقابلة أشخاص من خارج دائرتنا الاجتماعية المباشرة، والشعور بالحرية في تحديد العلاقات وفقًا لشروطنا الخاصة. ولكن هناك جانب مظلم لا يتحدث عنه الرجال دائماً بصراحة. لقد أصبحت الثقة سلعة نادرة. لقد رأيت الكثير من أصدقائي يتحملون الخيانة والغش والخيانة، وقد انكسر قلبي مرات كافية لدرجة أن جزءًا مني يتوقع خيبة الأمل كشيء افتراضي. عندما تتعرضين للأذى أو الخذلان في كثير من الأحيان، تبدأين في الاقتراب من العلاقات الجديدة وأنتِ في حالة تأهب. يبدو الأمر وكأنك تدخل كل تفاعل مع شخص ما وأنت تستعد للصدمة وتتوقع أن يسقط الحذاء الآخر. بالتأكيد، تبدو مهتمة الآنكما تظن, لكن امنحها شهرًا - ستشعر بالملل أو سيأتي شخص "أفضل". هذه الأفكار سامة، ولكن من الصعب التخلص منها بمجرد أن تترسخ في ذهنك.
لم تساعد تطبيقات المواعدة وثقافة المواعدة في المناطق الحضرية. من الناحية النظرية، فإن وجود خيارات لا حصر لها يجب أن يسهل العثور على شخص مميز. أما من الناحية العملية، فغالباً ما يحول الناس إلى خيارات بحد ذاتها - قابلة للتمرير السريع والاستبدال بلا حدود. هناك دائمًا تطابق آخر، أو دردشة أخرى، أو موعد محتمل آخر، فلماذا تستثمر بعمق في الشخص الذي أمامك مباشرةً؟ يصبح الجميع قابلين للاستبدال. نحن نشعر بهذا، وهذا يجعلنا نشعر بأنه يمكن التخلص منا أيضاً. وهذا له أثره النفسي. لقد شعرت بذلك بنفسي: بعد عدد كافٍ من العلاقات العابرة والدردشات الفاشلة، تبدأ في التساؤل عما إذا كنت يستحق شيء ذو معنى لأي شخص. أو إذا كنت مجرد صورة للملف الشخصي يتم رميها جانباً عندما تظهر الصورة التالية.
تولد هذه البيئة نوعًا من السخرية التي يصعب التخلص منها. يذهب العديد من الرجال (والنساء، لكي نكون منصفين) إلى المواعدة بعقلية دفاعية: لا تدعهم يرونك تهتم كثيرًا. نحن نتصرف بهدوء، ونبقي المحادثات سطحية، أو نتعامل مع عدة احتمالات حتى لا نشعر بالسحق عندما لا تنجح إحداها. إن العيش بهذه الطريقة مرهق عاطفياً. والمفارقة أننا نتوق بشدة إلى التواصل، ومع ذلك نشارك في ثقافة تقوضه باستمرار. في مدينة يسكنها الملايين، يمكنك أن تخرج في مواعيد غرامية كل أسبوع دون أن تشعر أبدًا بأنك تعرف أي شخص حقًا - أو أنه يعرفك. ومع مرور الوقت، يؤدي ذلك إلى شعور عميق بخيبة الأمل. بعض الرجال يتخلون عن المواعدة تمامًا لفترات طويلة، لأن العملية برمتها تبدو وكأنها الركض على جهاز المشي: تبذل كل هذا الجهد ولا تصل في النهاية إلى أي مكان، وربما حتى تتراجع بضع خطوات إلى الوراء من حيث الأمل والثقة.
غالبًا ما كان جيل آبائنا يتقابلون من خلال الأصدقاء أو العائلة أو المناسبات المجتمعية - كانت هناك مساءلة مدمجة ومستوى من الثقة العضوية. إذا أخطأ والدي، كان الخبر يصل إلى جدتي أو رئيسه في العمل أو أي شخص يهتم، لذا ربما كان يفكر مرتين. الآن، تلتقي بشخص لا وجود له في أي من دوائرك الاجتماعية. إذا ساءت الأمور، يمكنكما أن تختفيا من حياة بعضكما البعض بتمريرة واحدة ولا تواجهان أي عواقب حقيقية. أصبح اختفاء شخص ما أمرًا سهلاً للغاية لدرجة أنه أصبح متوقعًا عمليًا. وعلى الرغم من أنه أمر مريح، إلا أنه يساهم في انعدام الثقة المحيط. فنحن جميعًا مصابون بجنون الارتياب قليلًا، ومرهقون بعض الشيء، لأننا رأينا كيف يمكن للناس أن يتخلوا عن بعضهم البعض بسهولة. والنتيجة هي أن العلاقة الحميمة الحقيقية - من النوع الذي تتعرف فيه ببطء على روح شخص ما وتدعه يتعلم روحك - تبدو أصعب من أي وقت مضى، حتى مع كثرة العلاقات العاطفية أو العلاقات السطحية. إنها مفارقة تترك الكثير منا يشعر بالخداع والفراغ.
ظهور المعالج النفسي عبر الإنستغرام
وفي خضم كل هذه الفوضى، لا عجب أن يبحث الرجال عن التوجيه والإرشاد. وبالفعل، في كل مكان تلتفت إليه تجد النصيحة - الكثير من النصائح. لقد شهد العقد الماضي انفجارًا في ما أعتبره علم النفس الأدائي وثقافة العلاج الشعبي. تصفح انستجرام أو تيك توك وسترى عددًا لا يحصى من جرعات الحكمة: اقتباسات تحفيزية عن حب الذات، ورسوم بيانية بارعة عن الصحة النفسية، ومدربين "ذكور ألفا" يقدمون نصائح عن الثقة، أو معلمين في العلاقات أعلنوا أنفسهم كمعلمين في العلاقات يقدمون لك نصائحهم المثيرة عن سبب بقائك أعزب. من الناحية النظرية، من الرائع أن نتحدث أكثر عن الصحة النفسية والعواطف. لقد بدأت وصمة العار التي تحيط بالرجال الذين يطلبون المساعدة في التخلص من هذه الوصمة. ولكن إلى جانب ذلك ظهرت موجة من المعالجين النفسيين الزائفين وبائعي المساعدة الذاتية السريعين، وقد يكون من المثير للجنون أن تتخطى ضجيجهم.
ليس كل مقدمي النصائح متساوون. فبعضهم محترفون مرخصون يقدمون رؤى قيمة، ولكن العديد منهم مجرد أشخاص يتمتعون بجاذبية وزاوية نظر، ويستغلون تعطشنا للحصول على إجابات. سيعدونك بعلاج صدمتك أو "إطلاق العنان لإمكاناتك الذكورية" إذا اشتريت دورتهم التدريبية عبر الإنترنت أو اتبعت برنامجهم المكون من عشر خطوات. لقد نقرت على تلك الروابط في أوقات عصيبة - لست فخورًا بذلك، لكنني كنت يائسًا - وعادة ما تكون نفس التفاهات المعاد تدويرها. فكّر بإيجابية. اذهب إلى النادي الرياضي. اطحن بقوة أكبر. كلا، انتظر، قلل من الطحن وتأمل. قد تشعر وكأنك على أرجوحة: في لحظة يُطلب منك في لحظة ما أن تتبنى الضعف، وفي اللحظة التالية أن تتوقف عن الضعف وتثبت نفسك. إن الرسائل المختلطة لا تنتهي، وغالباً ما تتركنا في حيرة من أمرنا أكثر مما بدأنا.
حتى أصدقاؤنا وعائلتنا ذوي النوايا الحسنة يمكن أن يصبحوا علماء نفس على كراسيهم ويتداولون المصطلحات التي يقرؤونها على الإنترنت. وفجأة يتحدث الجميع عن أنماط التعلق أو يشخصون حبيبهم السابق على أنه نرجسي أو والدهم على أنه "ذكوري سام". هذه المفاهيم لها مزاياها في السياق الصحيح، ولكن في غرفة صدى علم النفس الشعبي، غالبًا ما يتم تبسيطها بشكل مفرط وإلقاءها ككلمات طنانة. إذا تجرأ الرجل على التعبير عن شعوره بالضياع أو الاكتئاب، فقد يحصل على نصيحة سطحية في المقابل: "هل جربتِ العلاج النفسي؟" أو "عليك أن تحب نفسك أولاً يا أخي." لا يعني ذلك أن هذه الاقتراحات خاطئة - فالعلاج النفسي مهم، وحب الذات أمر بالغ الأهمية - ولكن الطريقة التي يتم تقديمها بها قد تبدو رافضة، كما لو كانت مجرد وضع علامة في صندوق: تم ذكر المشكلة، وتم تقديم حل عام لها، وأغلقت القضية.
الحقيقة هي أنه لا توجد حلول سريعة لما نمر به. لا يمكنك علاج الوحدة العميقة أو أزمة الهوية بتغريدة تحفيزية أو حلقة بودكاست. النمو النفسي الحقيقي بطيء، وغالبًا ما يكون مؤلمًا وشخصيًا للغاية. فهو يتطلب عملًا فعليًا - أحيانًا مع متخصص، وأحيانًا من خلال الاستبطان، وغالبًا ما يكون كلاهما معًا. لكن الثقافة المحيطة بنا تجعل الأمر يبدو وكأننا إذا قرأنا الكتاب الصحيح أو تابعنا الشخص المؤثر المناسب، سنكتشف سر السعادة. وعندما تفشل هذه الوعود حتمًا، فمن السهل أن نشعر بالإحباط أكثر. يبدو أن الجميع يقومون بإصلاح حياتهم، لماذا ما زلت أنا أعاني؟ نتساءل. والحقيقة بالطبع هي أن الجميع يعانون، لكنهم على وسائل التواصل الاجتماعي يؤدون أداءً يدل على العافية والنجاح، تماماً كما نؤدي نحن في كثير من الأحيان كوننا "بخير" في حياتنا اليومية. إنه أداء تمثيلي، ويمكن أن يخلق مرآة مشوهة تجعلنا نشعر بالعيب عندما لا نستطيع حل مشاكلنا بدقة كما توحي لنا بكرة إنستغرام.
كرجال، نجد أنفسنا عالقين بين رغبة حقيقية في التحسن - لنكون أكثر سعادة وترابطًا وإشباعًا - وبين شكوك عميقة في كل رسائل المساعدة الذاتية الماكرة. نريد أن ننفتح، ولكننا لا نريد أن نتعرض للخداع أو أن نُباع زيت الثعبان. نريد أن نتعافى، ولكننا لسنا متأكدين إلى أين نتجه عندما يبدو الكثير مما هو موجود في الخارج وكأنه صخب أو غرفة صدى. إنه أمر محبط، ولكنني أحاول تذكير نفسي (وأي أخ يقرأ هذا المقال) بأنه لا بأس من ضبط الضوضاء. لست مضطرًا إلى ترديد المانترا أو شراء دورة تدريبية لمعلم لتبدأ العمل على نفسك. في بعض الأحيان يبدأ الأمر بشيء بسيط مثل محادثة صادقة مع صديق، أو كتابة ما تشعر به، أو نعم، البحث عن معالج نفسي حقيقي يبدو مناسباً لك. قد يكون سيرك علم النفس الأدائي صاخبًا، لكن لا يجب أن يكون نمونا الشخصي أداءً علنيًا. يمكن أن يكون هادئًا وحقيقيًا ويتم بشروطنا الخاصة.
بمفردك، بالاختيار أم بالصدفة؟
مع كل هذه الضغوطات وخيبات الأمل، ليس من المستغرب أن ينسحب العديد من الرجال إلى العزلة. في الواقع، بدأت الوحدة تبدو وكأنها معقولة خيار، حتى وإن كان مرغوبًا فيه، بالنظر إلى البدائل. لقد بدأ المجتمع ببطء في تطبيع صورة الرجل العازب. لم يعد العازب مدى الحياة موضع شفقة تلقائيًا؛ بل أصبح محسودًا في بعض الأحيان. تبدو عبارة "القيام بشؤونك الخاصة" مقوية. وفي الحقيقة، هناك قوة في العزلة. لقد تعلم الكثير منا الاستمتاع بصحبة نفسه. نتابع هواياتنا أو وظائفنا أو مشاريعنا الشخصية بشغف. نحن نقدر الهدوء والحرية التي تأتي مع عدم الخضوع لأحد. بعد كل الدراما والتوقعات المحبطة، يمكن أن نشعر بالوحدة وكأنها ملاذ آمن.
ولكن هنا تكمن المشكلة: هناك خيط رفيع بين العزلة كخيار صحي والعزلة كدرع واقٍ من الألم. الكثير من الرجال (وأنا أشمل نفسي هنا) اختاروا في بعض الأحيان أن يكونوا وحيدين لا لأننا اكتشفنا شكلاً مستنيراً من أشكال الاستقلال، ولكن لأننا مرهقون. لأن المحاولة والأمل والألم أصبحا أكثر من اللازم، لذلك قلنا لأنفسنا أن الأمر أفضل بهذه الطريقة. نحن نقول "أنا أحب حريتي؛ لا أريد أن أستقر،" وربما جزء منا يعني ذلك. ومع ذلك، في وقت متأخر من الليل، في تلك الشقة الهادئة، عندما نكون صادقين، نعلم أن الوحدة أصبحت رفيقنا غير المرحب به. نحن نتحملها، بل ونحتضنها في العلن، لأنها على الأقل مألوفة ولا يمكنها أن تؤذينا كما يفعل الناس.
من المذهل كيف يمكن أن يصبح نمط الحياة هذا "طبيعيًا" بسرعة. تعتاد على إعداد العشاء لشخص واحد، والعودة إلى المنزل في هدوء، والتخطيط لحياتك بالكامل حول نفسك. مرة أخرى - يمكن أن يكون ذلك مقبولاً! بل يمكن أن يكون رائعاً لفترة من الوقت. لا يحتاج كل رجل إلى زوجة أو أطفال أو حياة اجتماعية صاخبة ليكون راضياً. ولكن بالنسبة للكثيرين منا، هذا التطبيع للعزلة هو سلاح ذو حدين. فكلما زاد تطبيعنا لها، قل ميلنا إلى الخروج منها. تزداد الجدران من حولنا ارتفاعًا. ونقنع أنفسنا بأن الناس لا يمكن الاعتماد عليهم، أو أننا فقط "ليست علاقة عاطفية" أو أن لا أحد يريدنا على أي حال، فلماذا العناء؟ إنها آلية دفاعية تتكلس لتصبح أسلوب حياة.
لقد وجدت أن الخطوة الأولى للخروج من هذا الفخ العقلي هي خطوة بسيطة للغاية: الاعتراف بما نشعر به حقًا. بالنسبة لي، كتابة هذه الكلمات هي جزء من هذا الاعتراف. الحقيقة هي أنني لا يريد أن يكون وحيداً للأبد لا أعتقد أن معظم الرجال يريدون ذلك حقًا. نحن نريد صداقات حقيقية، وحب، وعائلات، ومجتمعات - كل الأشياء التي تعطي الحياة لونًا ومعنى. إن الاعتراف بهذه الحاجة وهذا الضعف أمر صعب. إنه يتعارض مع كل البرمجة. ولكن من التحرر أيضًا أن نقولها فحسب: أشعر بالوحدة أحياناً. أشعر بأنني متروكة. أريد المزيد. هذه العبارات لا تجعلنا أقل رجولة؛ بل تجعلنا بشرًا. وهي تفتح الباب، ولو بشكل بسيط للتغيير.
لا توجد خاتمة دقيقة لمشكلة بهذا التعقيد، ولكن هناك بصيص من الأمل. أرى المزيد من الرجال بدأوا في التحدث عن هذه المشاعر، سواء في منتديات مجهولة على الإنترنت أو في حديث هادئ من القلب إلى القلب مع صديق. وهذا أمر مهم. كلما قمنا بسحب هذه المخاوف إلى الضوء، كلما قلّت سلطتها علينا. تزدهر الوحدة الذكورية الحديثة في السرية والخجل، لذا فإن الحديث عنها هو نوع من التمرد - طريقة لكسر الصمت الذي يعزلنا.
إلى أين نذهب من هنا؟ ربما يكون الطريق إلى الأمام بالنسبة للرجال في عشرينيات القرن الحالي هو صياغة هوية جديدة من الألف إلى الياء. هوية لا تتحدد فقط من خلال ما نقدمه أو مدى مناعتنا ضد الألم. يمكننا أن نتعلم أن نجد قيمة ذاتية تتجاوز الراتب أو الفتوحات الرومانسية. يمكننا أن نكون مرشدين لبعضنا البعض، وأن ندعم عواطف بعضنا البعض، وأن نسمح لأنفسنا بالثراء العاطفي دون خجل. قد يعني ذلك إعادة تعريف الصداقة، أي أن نجعل من المقبول الاتصال بصديق والتحدث عن أشياء أعمق من الرياضة أو العمل. قد يعني ذلك التخلي عن الكبرياء الذي عفا عليه الزمن والاتصال أخيرًا بذلك المعالج النفسي، ليس لأن شخصًا ما على إنستغرام طلب منا ذلك، ولكن لأننا مدينون لأنفسنا بالرعاية.
من ناحيتي، أحاول أن أتذكر أن كوني وحيدة الآن لا يعني أن أكون وحيدة إلى الأبد. أنا متمسك بالأمل بأنني بصدقي - بكتابة مقال كهذا، وبدء هذه المحادثات - أقطع وصمة العار. ربما يتعرف شخص آخر يقرأ هذا المقال على جزء من نفسه في هذه الكلمات ويشعر بعزلة أقل قليلاً. ربما سيضع هاتفه جانبًا بعد قراءة المقال ويقرر إرسال رسالة نصية إلى صديق ليحتسي الجعة أو القهوة ويتحدث بالفعل. ربما سأفعل الشيء نفسه.
العالم من حولنا صاخب وسريع وغالبًا ما يكون غير مبالٍ، لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نكون كذلك. يمكننا أن نختار، شيئًا فشيئًا، أن نتواصل ونستمع ونبني الثقة من جديد. يمكننا أن نختار أن نؤمن بأن قيمتنا لم تختفِ لمجرد أن العلامات القديمة للرجولة قد تغيرت. في النهاية، قصة الرجل الحديث ليست مجرد قصة وحدة، بل هي قصة مرونة وانبعاث من جديد. نحن نكتب تعريفات جديدة لأنفسنا - أحيانًا بشكل مؤلم، وغالبًا بشكل أخرق، ولكن بصدق. وبينما نفعل ذلك، قد نكتشف أننا لم نكن أبدًا وحيدين حقًا كما كنا نظن.




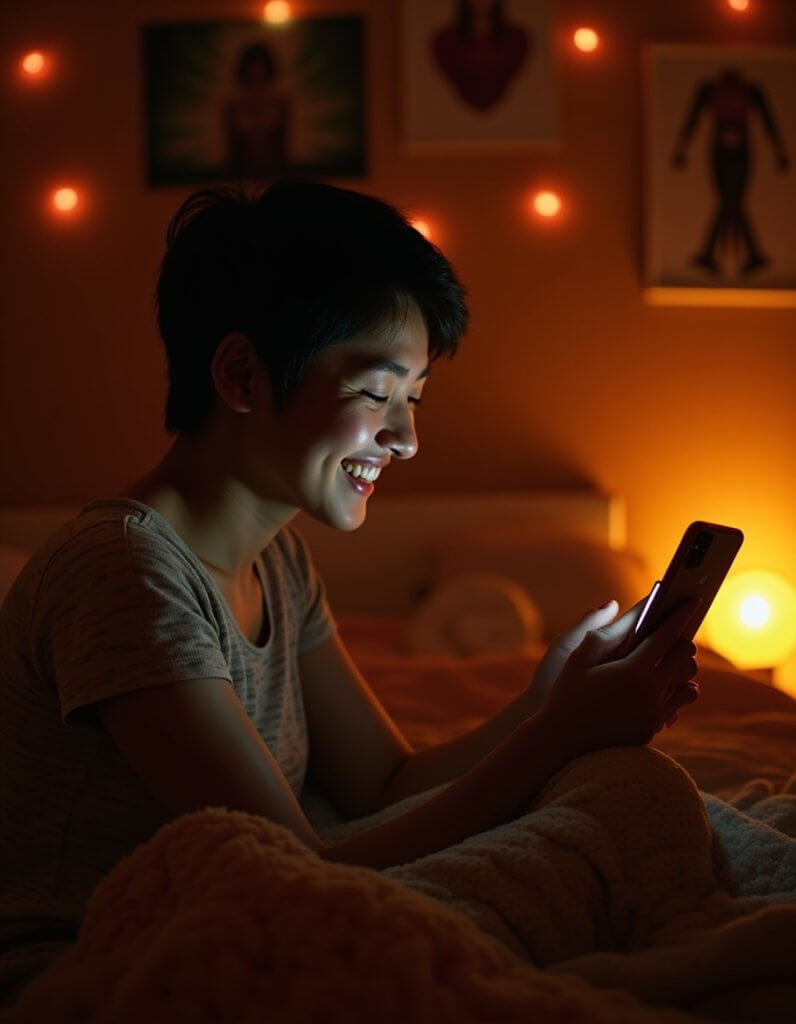









Muy bueno, pero prefiero estar solo.
Fantástico, pero te falto lo mas importante: El daño del feminismo de la 3ra 3 y 4ta ola y el tema de la repartición de la repartición de bienes y patria potestad siempre a favor de las mujeres como factor determinante para decidir transiditar el camino de la "soledad".
Но, у меня нененя не не не не не друга). Спасибо за поста، чень в тему، я задумалась!
non si CUCCA più è quello il problema ….